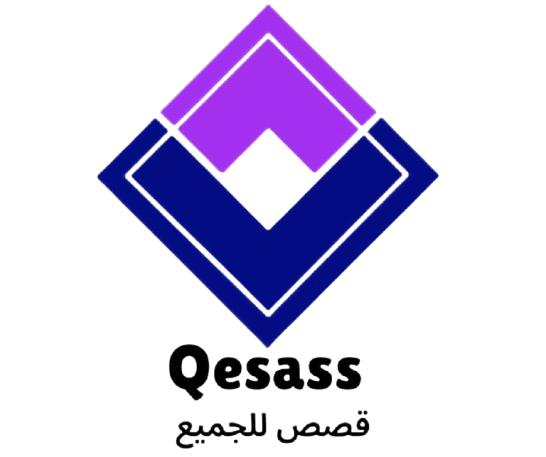قصة مطاردة بلا ذاكرة

أكتب هذه الصفحات بصوت رجلٍ يحاول أن يجعل وقائع الليالي الأخيرة قابلة للثبات قبل أن تتلاشى. ليس هدفُي المجد أو الانتقام، بل توثيق شيء واحد: كيف صارت ذاكرة الناس سلعة تُباع وتُفرّغ، وكيف تحولت المدينة إلى خرائطٍ منظفة من أسمائها. ستجد هنا لحظات مطاردة، لافتات صغيرة، ونقطة سوداء كرّمتها الأيادي التي لا تعرف أنها تُستخدم. اقرأ بعين من يريد أن يفهم، لا بعين المتفرج.
القصة
كتبت هذا لأنني أحتاج أن أضع حدثاً في مكانٍ واحد قبل أن يبتلعني النسيان تماماً. أريد ورقة تثبت أنني عشت، أو على الأقل أنني كنت موجوداً في اللحظات التي تحوّلت فيها مدينتي إلى شبكةٍ من ظلال لا تعرف نفسها.
أول مرة رأيته كان خلف رفوف محل بقالة، تحت ضوءٍ هزيلٍ أصفر. لم تكن عيناه تبحثان عن شيء. كان ينظر كما ينظر من فقد شيئاً لا يمكن استعادته بكلمات. قال لي كلمة واحدة ثم ابتسم كما لو كان يتذكّر نكتةٍ قديمة: العودة. لم أعرف لماذا أثارت تلك الكلمة قلقي إلى هذا الحد، لكنني لم أستطع التخلص من الانطباع أن في عمره عالماً من الفراغ.
بدأت المطاردة من بلاغ بسيط. شحنة صغيرة، طريق مكرر، رجل يختفي وسط تفاصيل لا تُحسب. لكن كما يحدث دائماً، ما يبدأ صغيراً يصبح خرائط. لاحظت نمطاً متكررًا على موقعي الجرائم: شريط لاصق عليه نقطة سوداء، صغيرة جداً، توضع على الأبواب وعلى صناديق البريد وعلى مقابض المحلات. لم يكن الشريط دلالة على الاحتراف، بل على طقس. من يلمسه يتغير. الذاكرة القصيرة تصبح ملفاً مهترئاً. الناس ينساون الحاضر قبل أن يدركوا أن شيئاً اختفى.
المدمنون لم يعودوا يتركون آثارهم. كانوا يمشون كمن يمشي في حلم، يكررون نفس الطريق، يوقفون سياراتهم عند نفس الزاوية، ويتوقفون كما لو أن شيئاً خارجياً يسحبهم إلى ما لا يخصّهم. حاولت سؤال أحدهم. نظر إليّ كمن استيقظ لتوه من نوم طويل، ثم قال اسماً لا أعرفه. عندما سألت عن أبنائه ردّ بعينين خاويتين: هيا نذهب. لم يعد الكلام أداة لربط الناس بالعالم، صار شيئاً يطفو فوق فراغ.
المروج كان أكثر هدوءاً من المطلوب. لم يكن زعيم عصابة بالشكل التقليدي. كان رجل معلومات، يجمع نماذج وأسئلة، يبيع القدرة على أن تنسى. لم يخبره أحد أنه يبيعها. بدا له وكأنه يحرر الناس من حملٍ ثقيل. وصف ما يفعله كخدمة. كان يتكلم بلطفٍ يثير الاشمئزاز، كما لو كان يعرض كتاباً في مكتبة صغيرة: “أعيد لهم الصمت. أفرّغ رؤوسهم من الأشياء التي تؤذيهم.” صوته كان مريحاً، لكنه كان يسرق الحقائق.
حضرت إلى مستودعٍ عن طريق أثر نقطة سوداء. الباب كان مفتوحاً. الداخل كان مرصوفاً بأكياس بلاستيكية وعلب. على الطاولة كانت هناك بلاطات صغيرة ملفوفة بورق شفاف. شممت رائحة كيمياء باهتة، غير مزعجة لأول وهلة، لكنها بقيت في الأنف مثل بداية نزيف. في الزاوية كانت مجموعة من الصور القديمة. وجوه بدون أسماء. عندما اقتربت اكتشفت أن بعضها يحمل وجوهاً أعرفها، لكن ليس كما أعرفها. كانت وجهي ضمن الصور، لكن في صورة واحدة كنت أصغر بعشر سنوات، بزي لم أرتده أبداً، بوجهٍ لا أعرفه إلا لأنه أنا.
لم أستطع القبض عليه في تلك الليلة. الرجل اختفى كما تختفي الأسماء من دفتر مذكرات قديم. لكن أخذت معي عينة صغيرة. لم أفكر أني تلامستها. لم أعد أعرف متى وضعتها في جيبي. ربما لم ألمسها، وربما لم يكن هناك فرق. بعد يومين بدأت ألاحظ أشياء صغيرة: مفاتيحي في غير مكانها، اسم قائد الدورية الذي ظننت أنني تحدثت معه أمس، لكنه قال أنه لم يرني منذ أسابيع. توقعت إهمالاً أو ضغط عمل. لكن عندما جلست في سيارتي لأكتب مذكرة عن تقدم التحقيق، وجدت أن ورقة عملي فارغة من السطور التي كتبتها منذ ساعة.
الدوائر بدأت تُسكر. عند الاستيقاظ أجد مفاتيح لم أضعها، رسائل على هاتفي لا أتذكر إرسالها، وأحياناً طريقاً إلى مكانٍ لم أتعقب كيف وصلت إليه. كنت أراجع تسجيلات الكاميرات، أبحث عن أي لقطة تُثبت أني كنت في موقع ما، لكن التسجيلات كانت تحمل فجوات. لقطات تنقطع لثوانٍ صغيرة في اللحظات التي أحتاجها فيها. كأنما أحدهم يقطع شريط النهاية في مشهدٍ مفصلي.
المدمنون تحوّلوا إلى خزائن نسيان. لا يطلبون المال، لا يحتاجون للأدوية، يحتاجون فقط لأن يُتركوا. كانوا يضعون أشياء شخصية في صناديق عندنا أمام المباني العامة. كنت أفتح صناديقهم لأرى ما فقدوه: صور عائلية ممطوطة، بطاقات هوية بها أسماء، مفاتيح، ألعاب أطفال. كل تلك الأشياء لم تعد مرتبطة بذاكرة من يحملها. تجمّع حولهم صمتٌ جماعي، ليس الذي يخرج من وجود الشفقة، بل الصمت الذي ينتظر أن يُعاد تهيئته من جديد.
في مرحلة ما بدأت ألاحظ تكراراً غريباً: أسماء من قوائم المفقودين تُذكر في نفس الأزمنة التي يظهر فيها الشريط الأسود. لم تكن مجرد مصادفة. ثم ظهر اسم صديقي القديم على لسان أحدهم. لم أره منذ سنوات. تذكرت ليلة حين غبت لأسباب لا أتذكرها الآن. أشعر بفراغٍ هناك، مكانٌ مفقود في ذاكرة لا أعلم إن كانت ملكي أو لقصة كتبتها ليلاً ونسيْت أن أنهيها.
المروج لم يكن يسرق الذاكرة ليُخفي منهجاً إجرامياً، بل ليبني شبكة. شبكة من أشخاص لا يتذكرون أنهم بشر، فتُستخدم أجسادهم كأقنعة. إذا لم تتذكر أن لديك ذاكرة، يمكنك أن تحمل رسالة، أو شحنة، أو تفتح باباً. لقد أدركت أن نواهية التهريب كانت في الاعتماد على أملاك مختلة الذاكرة. تلقى الرجل وظيفة لا تحتاج إلى تواطؤ. يكفي أن تضع نقطة سوداء على ذراع واحد ثم يذهب دون أن يتذكر.
الليلة التي اعتقدت أنني سأمسك بها كانت مختلفة. وصلت إلى بناءٍ قديم حيث كان هناك جدول توزيع. وجدت ملفَ أوراقٍ مكتوب عليه كلمات بسيطة: أسماء، تواريخ، أماكن. وفي أسفل الصفحة كان هناك عمود صغير من الأرقام، رسائل مشفّرة؟ عندما رفعت أحد الصور وجدت وجوهًا مألوفة، وجوه يقاربون وجهي لكنه مشوّه، مبتسماً بطريقة لا أعرفها. وفي ظهر الصورة، عبارة مكتوبة بخطٍ صغير: أنت التالي.
لم أعد أملك يقيناً أن هذه النهاية ستكون نهاية لعصابة. لم أعد أملك يقيناً أنني لن أكون مجرد اسمٍ يطويه الغبار في سجلّ الشرطة. كتبت هذه الصفحات لأحاول أن أمسك بخيطٍ قبل أن ينقطع. إن قرأت هذا، فافهم أن الخطر ليس في مادةٍ مخدرة بمفهومها التقليدي. الخطر في فكرة تُعطيك الفرصة أن تنسى أن لك ذاكرة.
أعلم أن كل خطوة قد تكون مرسومة لختامٍ لم أكتبه بعد. أعرف أني قد أركض نحو نقطةٍ سوداء دون أن أدركها. أعرف أيضاً أن الاعتراف هنا قد يكون آخر شيء أتركه. أكتب لأنني لا أريد أن أكون ظلّاً آخر في شبكةٍ لا تعرف أن لها حدوداً. إذا عدت ووجدت أني لم أعد أكتب، فاعلم أنني ربما لم أعد أتذكر. وإذا لم تتذكر أنت أيضاً، فلن يعرف أحد أن شيئاً ما قد حدث.
النهاية