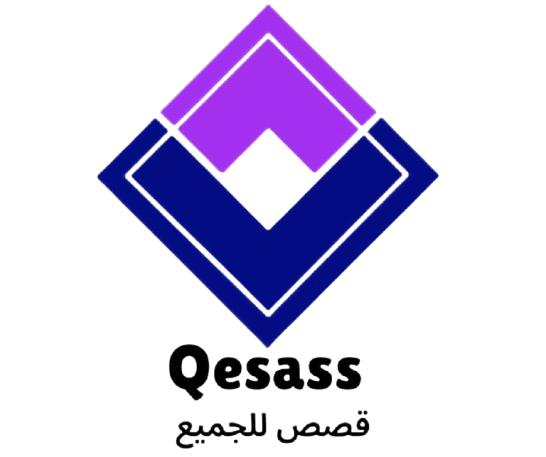قصة إعتراف المجرم الأخير ج4 والأخير

هنا لا مجال للتراجع ولا مساحة للمناورة. في هذا الجزء تصل الاعترافات إلى نهايتها، وتتحول المواجهة من لعبة عقول إلى ثمنٍ يُدفع كاملاً. السارق يخرج من الظل، والمدينة تُجبر على النظر في المرآة، بينما تتحرك قوى لا تسمح للحقيقة أن تنتصر بلا دم. هذا فصل الحسم، حيث تختلط الحقيقة بالتضليل، ويُكتب المصير بطريقة موجعة وحزينة، لتبقى الأسئلة معلقة حتى بعد إسدال الستار.
القصة
لم يبق شيء لأخفيه. لم يعد لديّ صبر لأحافظ على وجودي كظلٍ بين الورق والكاميرات. قررت أن أنهي اللعبة بطريقة تجعل المدينة لا تستطيع بعدها أن تتظاهر بالنسيان. كانت خطتي الأخيرة بسيطة في مظهرها وصاخبة في أثرها. سأجعل الحقيقة تُبث على الهواء مباشرة. سأجعل كل من نراهم كوجوه محترفة يتلقى حكم الجمهور في لحظة واحدة. بهذا الشكل فقط يمكن أن أضمن أن الكذب لن يعود لينجب أكاذيب جديدة بسهولة.
اخترت مكاناً رمزياً. ليس مبنى حكم ولا مقر شرطة. اخترت مبنى صغير في قلب المدينة، مبنى متصل بتلفزيون محلي يحترمونه لأنهم يخافون منه. حجزت غرفة بسيطة، أعددت ملفات لا تعد ولا تحصى، جهزت قوائم بالأسماء والعقود والوثائق التي لا تترك مجالاً للكراء. لم أضع قنابل. لم أرد أن أموت من شدة غضبي. لم أرد أن أجرح آخرين عن عمد. أردت أن أصنع صدماً لا يمكن محوه. أردت أن يرى الجميع أنهم كانوا يلعبون لعبة مع ورقة واحدة فقط. عندما ينهار المسرح أمام العين، لا يعود ممكناً أن تقول إن شيئاً لم يحدث.
في الليلة الموعودة دخلت بأقل حراس ممكن. ربطت بثاً مباشراً لا يمكن قطعه بسهولة. ألقيت بالملفات على الطاولة. فتحتها واحدة تلو الأخرى. بدأت أتلو أسماء، تواريخ، أرقام حسابات. لم أقرأ مثل كاتبٍ يحسب كلمات. تحدثت بصوتٍ يجعل الهواء يجمّد. قلت الحقائق لا لأنتقم بل لأجبر الناس على أن يتذكروا. قلتها بصيغة لا تسمح للشك. ومن داخل الغرفة، من الكاميرا، انتشرت الحقيقة مثل نارٍ لا تعرف الرحمة.
الشارع انفجر. الناس لم يصدقوا في البداية. ثم القنوات أعادت البث. الحشود شكلت أمواجاً أمام مباني السلطة. الصحف طبعت أرقاماً لم يجرؤ أحد على طباعتها من قبل. مكاتب مسؤولي المدينة انهارت كلمةً وراء كلمة. الضابط سامي ظهر على الشاشة محاولاً أن يرد. صوته كان رطبا. ساعات من الإنكار تلاها هدوء غريب. حينها أدركت أن عملي قد بلغ الذروة.
لكن القوة التي لا تظهر إلا في الظلال لم تكن لتحب هذا النوع من الضوء. الرجل الغامض الذي تابعت أثره، ذلك العقل الذي اعتاد أن يسوّق الضمانات والصفقات خلف ستار، لم يقبل أن يترك العرض يسرق منه السيطرة. لم يقبل أن يُنهى كل شيء بعرض واحد في قناة صغيرة. أرسل رجاله. لم يرسلوهم ليقتلوني على الفور. هذا ليس أسلوبهم. أرسلوهم ليأخذوا أمراً واحداً. أن يغيّروا مسار المشهد بقطة واحدة. أن يجعلوه عنّي بدل أن يكون عنهم.
بينما كنت أقرأ من ملف إلى آخر، سمعت خطوات في الممر. لم أرتبك. تعلمت ألا أرتبك. لكن الخطر كان في السرعة. دخلوا الغرفة بمظهر موظفين. لم يكشفوا وجوههم. تحدثوا بلا مبالاة. قال أحدهم عبارة قصيرة واضعةً لها ثقل الأمر: “توقف. هناك من يريد التفاوض.” لم أرد. قلت لهم إن التفاوض انتهى عندما اختفى أول إنسان تحت روتينهم. همسوا ثم غادروا. لم أفهم حينها لماذا تركوني أواصل.
بث الحقيقة استمر. عشرات الأسماء سقطت في جدول واحد. وعي المدينة بدأ يهدأ نحو غضبٍ أكثر تركيزاً. ثم حدث ما لم أكن أتوقعه. أحد زعماء الظل قرر أن ينهي القصة بسطر واحد. لم أرَ وجهه. لم أرد أن أراه. لكنه أرسل رسالة قصيرة للكاميرات. صورة واحدة. صورة لي مع رجلٍ لا أحب أن أذكر اسمه. وصفوا المشهد كما لو أنني أتلقى أموالاً مقابل نشر الفوضى وزعزعة استقرار البلاد. أضافوا تهمةً جديدة. في لحظةٍ تحولت القضية من كشف فساد إلى مطاردة شخصية.
الشرطة انقسمت. بعضهم أراد استكمال التحقيقات. البعض الآخر رغب في إقفال الملف لصالح النظام. الإعلام التفت من الوثائق إلى صورٍ مفبركة. ذلك الزلزال الإعلامي وضعني في مرمى الاتهام. وجوه ضباطٍ سابقين طفت على الشاشات، يبرّرون، يصرخون. سمعت أن سامي صار لا ينام. رأيت في عيون الرجال الذين عرفتهم سابقاً وجهاً خالياً من ثقة. الجنون بدأ في الهزّات الصغيرة. هم لم يجنوا بشكل ضحك جنوني. جنونهم كان واضحاً في أخطائهم المتتالية، في بياناتٍ لا معنى لها، في تضارب الأوامر التي لا تتوقف.
ثم جاء الليل الذي قرر فيه الظل أن يحسم اللعبة. لا يحتاجون إلى مفجرات. لديهم طرق أكثر دقة في إجهاض الضمائر. جاءوا للمبنى بعد منتصف الليل مرّتين. المرة الأولى حاولوا الدخول بصفتي. فشلوا. المرة الثانية اخترقوا نظام الحراسة في ممر الخدمة. لم أشعر إلا بوجودهم داخل الغرفة حين سحبوا الكاميرا من الحامل. ظلّ البث منقطعاً لدقائق بدت كقرون. عاد المشهد على الهواء لكن مع لقطة أخرى. لقطة لافتتاحية ملفٍ علقت بحقيبة بلاستيكية. صورة ملفٍ مفتوح يحمل خطابات مزيفة. الكاميرا لم تذكر كيف دخلت تلك الرسائل. الجميع شاهد. الجمهور صار قلقاً. الشرطة صار لديها سبب لتعتقلي. كانوا سعداء بهذا السبب.
لم أقاوم بشدة. لم أرد أن أجعل أحداً آخر يموت من أجلي. حاولت أن أتحدث. حاولت أن أقول إن هذه اللعبة أوسع من شخصي. لكن الأيدي التي أمسكَت بي كانت ثقیلة كتاريخ المدينة. زوج من الرجال من ذوي الوجوه الباردة أخذوني إلى مكان بعيد. لم أحتجز في زنزانة تحكمها قوانين. احتجزت في غرفة توضح أن النظام قادر على أن يقبض على أي رجل مهما كان حجمه. سمعت كلامهم يتخلله تهكم. لم يهمهم ما قلت. كانوا يعملون على رواية بديلة. الرواية التي تجعلني مجرماً فقط. الرواية التي تُطفئ السؤال عن من كان يبتز من ومن كانوا شركاء.
في صباح اليوم التالي خرجت الأخبار. قالوا إنني حاولت أن أؤجج الفوضى. نشروا صورا ملفقة. وجاءوا بدليل مزيف يدينني. الضابط سامي ظهر مرة أخرى على الشاشة. عيونه حمراء من السهر. صوته مرتعشاً لكن حازماً. قال إن الأمن أعاد المدينة إلى هدوئها. لا أحد تحدث عن الوثائق الحقيقية التي بثتها الليلة السابقة. الناس احتاجوا إلى اسمٍ يُغلق به الباب.
لم يدم الهدوء طويلاً. الحقيقة لها طرقها. رجال داخل الجهاز أفلتوا بعض الأسماء. نسخ محفوظة بدأت تنتشر في يدّ شبان لا يأبهون بسلطة ولا بخوف. جمهرة صغيرة بدأت تتساءل من الذي يحمي من. مظاهرات أعيدت. الناس لم تنسَ. الإعلام اضطر أن يكرر الوثائق التي بثتها. لكنني لم أكن هناك لأشهد ذلك. في السجن الذي وضعتني فيه، لم يكن لدي صوت. كثيرون كتبوا عني. البعض نعتني كمجرم. البعض الآخر نعتني كمرآة. ولم يعد أحد يتفق على تعريف واضح لبقائي.
بعد أيام قليلة نقلوني إلى مكان آخر. في الطريق ساد الصمت. لم أُعطَ فرصة للتوقف كثيراً عن التفكير. قبل أن يدخلوا بي باب غرفة التحقيق، نجح رجل الظل أن يُنهي عملي بطريقته الأخيرة. قالوا إن مهاجميّ الأعلام عثروا عليّ ميتاً داخل زنزانتي. لا سيف ولا طلق ناري تُروى تفاصيله. الجملة كانت كافية. الجملة كانت مثل قفلٍ على كل قصة. لم يرَني أحد بعدها حياً.
أخبروني عن التحقيق بعد ذلك. عن محاكماتٍ ظلت دون أوضح نتيجة. عن ضابطٍ فقد توازنه ظاهراً والآخرين يخبّئون وجوههم. عن رجل ظل ينسّق هبوب الصحف لصالحه. عن مدينةٍ تقرأ وتنسى وتعود لتسأل. أما أنا فلم أعد أعترض. لم أعد أملك قوة الكلام. انتهت قصتي على الصفحة التي قرأتها للتو. انتهت بضحكٍ لا أستطيع وصفه ولا بدموع يمكن إحصاؤها.
لكن هناك شيء واحد بقي واضحاً. لقد فعلت ما فعلت لأجل وجهٍ واحد. لأجل أخي الذي رحل بين دخان الليل. لم أعد أعرف ربما كنت مخطئاً في الوسيلة. ربما كنت مخطئاً في النتيجة. لكني لا أندم في مقاسٍ واحد. جعلتهم يخافون. جعلتهم يبحثون في أنفسهم. جعلت الشرطة تجن. هذه الجنون لم يكن هروبا من الحق. كان ارتداداً. وفي لحظة ما سيجلس أحدهم أمام مرآة ويعرف وجهه الحقيقي. حينها، مهما كانت النهاية، ستكون الحقيقة قد خرجت من فم القناع.
أنتهي هنا. ليس لأن العالم صار عادلاً. لأنني لم أعد قادراً على سرد أكثر. ربما ستتذكرني المدينة كوحش. ربما ستتذكرني كمرآة. ربما لا يتذكرني أحد. لكن في ليلٍ ما ستهتز لوحة أسماء وتنقش على حجر لا يزول. وربما حينها، سيعرف بعضهم أن الرجل الذي سمي بالأقوى كان مجرد إنسانٍ أراد أن يُخرِج صوت من تحت الرماد.
النهاية
بهذه النهاية تُغلق فصول هذه السلسلة، ما قرأتموه هو حكاية إنسان اختار طريقاً مظلماً، فدفع الثمن وحده ودفع معه أبرياء لا ذنب لهم. الرسالة هنا واضحة: الظلم لا يُصلح بالانتقام، والفوضى مهما بدت مبرَّرة لا تصنع عدالة حقيقية.
في منصة قصص حاولنا أن نقرّب القارئ من الجانب الخفي للأحداث، وأن نُظهر كيف يمكن للغضب واليأس أن يحولا الإنسان إلى أداة هدم قبل أن يكون أداة تغيير. هذه السلسلة موجّهة للشباب خصوصاً، لتأكيد أن الوعي، والصبر، والعمل الصحيح هي الطرق الوحيدة لصناعة التغيير، وأن الانجراف خلف العنف أو الفوضى لا يؤدي إلا إلى خسائر جديدة.
حرصت إدارة منصة قصص على الجمع بين التشويق والعِظة في آنٍ واحد، لنقدّم محتوى يشد القارئ دون أن يغفل عن المعنى، ويثير الأسئلة دون أن يضلّل العقول. نتمنى أن تكون هذه السلسلة قد لامست تفكيركم، ودفعتكم للتأمل قبل الحكم، وللاختيار الواعي قبل أي خطوة.