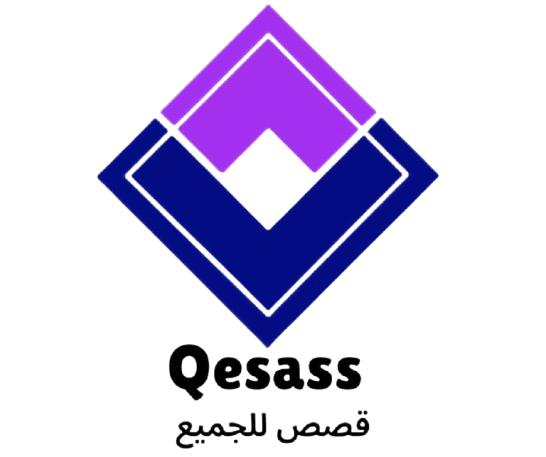في هذا الجزء ينتقل السارق من مرحلة الاعتراف إلى مرحلة المواجهة. لم يعد الأمر مجرد سردٍ لجرحٍ قديم، بل تحوّل إلى خطةٍ تتسع مثل دائرة حريق لا يمكن السيطرة عليها. هنا يبدأ تأثير أفعاله في ضرب المدينة من الداخل، وتبدأ الشرطة تفقد توازنها بينما يظهر لاعب جديد يدخل الصراع بصمت. يكشف السارق أسراراً أخفاها النظام لسنوات، ويقترب من نقطة لا عودة فيها، حيث يتحول الانتقام إلى معركة أعمق مما تصور. هذا فصل تتشابك فيه الخيوط ويشتد فيه الخطر، لتبدأ ملامح النهاية المظلمة بالظهور لأول مرة.
القصة
أعدتُ ترتيب الذاكرة كأنها حجر أمامي أضع عليه قطعة زجاج لأرى الانكسار بوضوح. السر الذي أبقاني حياً لم يكن تقنية ولا سلاح. كان قراراً يتكرر في داخلي كل صباح: أن أحول ألم فقدي إلى فعل يمكن أن يقرأه الآخرون، أن أجعل الألم مرئياً بحيث يُحكم عليه الجميع وليس فقط القتلة الظاهرون. لم أكن أريد ثروة، ولا مجد. أردت أن أخبر المدينة بصوتٍ واحد: أنكم أخطأتم وأنكم تدفعون ثمن أخطائكم.
الخطة بدأت كقصة قصيرة استطعت أن أخفيها داخل قصة أكبر. اخترت هدفاً ليس لأنه أقوى مادياً، بل لأنه كان رمزاً لكل ما آمنتُ أنه يحتاج إلى فضح. الرموز تُؤلم أكثر من الأموال. عندما تهدم رمزاً يخسر الناس أملاً. وهذه الخسارة كان لابد أن تشعل شيئاً تحت الرماد.
في ليلة لا أنساها، جلستُ أمام نافذة تطل على شارعٍ لا ينام، وكتبتُ رسالة لا تهدف للإعلان بل للتمثيل. لم تكن الرسالة تهديداً تقليدياً. كانت قصة قصيرة، مفصلة بدقة، تحكي عن طفلٍ تركوه خارج باب المستشفى. أسماء لم أذكرها مباشرة، أماكن لم أصوّرها بتفاصيل تساعد من يريد تقليد العمل. لكن الرسالة حملت رابطاً لمجلدٍ واحد. المجلد لم يحتوي على خرائط أو تعليمات. احتوى على شهود، على صورٍ لشيءٍ لم يمر بدون أن يترك أثره. صور لم تسجل جريمة بعنف، لكنها سجلت تجاهلاً، تجاهلاً بسيطاً لكنه قاتل.
أرسلت ذلك المجلد، عبر طرقٍ لا أوردها، إلى خمسة أشخاص في منابر الإعلام المحلية. لم أطلب منهم أن ينشروا. تركت لهم الحرية للقراءة فقط. كنت أعلم أن الفضول أكثر فتكاً من الحقد. الفضول سيأخذهم إلى الشيء. واحد منهم لم يصبر. نشر مقتطفات لا أكثر. ثم بدأ الهاتف يرن في كل القنوات. ثم بدأت العيون تنظر إلى المبنى الذي اعتاد أن يكون طاهراً.
ما حدث بعده لم يكن خطة محكمة. كان رد فعل متسارع. رجال الإدارة جلسوا في غرفهم البيضاء، وأخذوا يوزعون كلمات جاهزة عن التحقيق والشفافية. ضحكاتهم في الكواليس كانت أقسى من أي صفعة. أحدهم قدم استقالته بعد يومين بغلاف تغطيه العافية الشخصية. لم يمضِ أسبوع حتى افتُتِح تحقيق رسمي. هل أردت هذا؟ نعم. أردت أن يُسألوا أمام الجميع عن الأشياء التي جعلتهم بشراء صفحتي. أردت أن أسمع عشب السلطة يُقطَع إلى حبلٍ لا يصل لأحد.
الشرطة، بطبيعتها، لا تحب أن تُحرج. الضابط الذي كانوا يضعون صورته على الشاشات أصبح وجهاً للتوتر. هم ينتظرون أدلة ملموسة، بصمات، شهادات. أنا لم أعطهم شيئاً من هذا. صنعتُ لهم لغزاً من مراثي ضحاياهم. جعلتهم يبحثون عن متهم وهمي لأن الذي كشفته كان أكبر من شخص واحد. لقد جعلتهم يجوبون المدن بحثاً عن ظلي. هذا ما يجعلهم يفقدون توازنهم. البحث عن الظل ينهك الإنسان لأن الظل لا يترك ورقةً واحدةً خلفه.
في الأيام التالية ارتفعت الحرارة الإعلامية. الناس تتحدث في الأسواق عن أسماءٍ تذكرتها الرسائل. أقاربٌ قديمون بدأوا يطلبون مقابلات. وفي اللقاءات التلفزيونية بدأ الضابط الأكبر على الخيوط كما لو أن روحاً تأكل في داخله. همس إليه رجل من جهازٍ آخر أن لا يجعل الفضائح تتسع لأن ذلك يفتح باباً لا غلق له. الضابط، في لحظة إنسانية، نام على مكتبه، ويداه ترتعشان. رؤيته بهذه الحالة كانت شحنة لازمة داخل قلبي. انتصاري لم يكن مكتوباً في استقالة ولا في تحقيق. كان مكتوباً في ذعرٍ صغير امتد إلى صدر رجلٍ كان يمثل قوة الدولة.
لكن الانتصارات تجلب العيون الجديدة. عيون أكثر خبثاً وأكثر حرصاً على عدم الظهور. ظهر شخص آخر لم أكن أتوقعه ضمن اللعبة. رجل لديه موارد، لا يعمل داخل المؤسسات لكنه قريب منها. اسمه لا يعنيني هنا. ما يعنيني أن هذا الرجل قرأ مخططي وكأنه يقرأ رواية، وأدرك ما أفعله بصورة مختلفة. لم يثر غضبه على الفور. ببطء صنع شبكة من الأسئلة التي قصدت بها أن تعيد تنظيم فقدي. هو لم يتحدث عن العدالة. هو تحدث عن التوازن. قال لي ذات مرة عبر رسالة قصيرة: “إن أردت تغيير النظام فأنت قد تفتح باباً لا تعرف ما الذي سيخرج منه. احذر أن يصبح ضحاياك بلا مأوى لأنك تريد أن ترد لهم حقاً.” لم أرد على رسالته. لكن التفكير بها جعلني أشعر أنني على حافة شيءٍ أكبر من انتقامي.
لم أكن معتاداً على الندم. الندم عندي كان يطل من الزوايا، يتحدث بصوتٍ خافت، يخبرني أن لكل فعل أثر لا يزول. بدأت أرى صور الأخ الذي فقدته ليس كمرساة تدفعني إلى الأمام، بل كمرآة تظهر وجهي فعلاً. في كل استجابة من المدينة، كنت أقرأ وجوه الناس لأعرف إن كانت أصواتهم تأتي من قلبٍ منحاز أو من خوف. بعضهم بكوا على الهواء. البعض الآخر رفعوا لافتات يظنون أنها تضامن مع العدالة. لكن الأكثرية لم تفعل شيئاً سوى الاستمتاع بالدراما. وهذا كان أكثر ما يؤلمني. هل كانت قصتي مجرد مسرح؟ هل احتاج العالم لعرضٍ ليهتز؟
ثم جاءت الضربة الكبرى. لن أذكر تفاصيل تقنية لأنني لست هنا لأعلّم أحداً كيف يكسر أبواباً أو يخترق أجهزة. سأقول فقط إنني اخترت أن أفضح ليس شخصاً واحداً بل مجموعة من الاتفاقيات المكتوبة بخطٍ رفيع. كشفت عن عقودٍ رخصت خدمات كانت تُفقد بها حياة الناس مقابل أرباح زهيدة. لم تكن تلك العقود تتفق مع أخلاقياتنا. لم تكن خاطئة بمجرّد كونها غير معروفة. كانت خاطئة لأنها وضعت إنساناً ضد إنسان. النتيجة كانت انفجاراً في الشارع. الناس خرجت تعبر عن غضبها، لكن الغضب لا يغيّر شيئاً بسرعة. ما غيّر شيئاً هو أن نفوذ البعض بدأ يتصدع أمام أعين الجميع.
الشرطة جنّت. أعني بها أن النظام بأكمله بدأ يصرخ. اجتماعات طارئة. تحريك ملفات. تصريحات متتالية عن تسريع التحقيق. لكن مع كل تصريح لهم كنت أُشعر بأنهم يختبئون خلف كلمات طويلة لكي لا يُلمس أحدهم. وأنا كنت أطبع على فوهة الرصاصة كلمة واحدة: المسؤولية. كانت مهمتي أن أجعلهم يواجهون كلمة ليست سهلة عليهم.
وفي وسط هذا، علمتُ أن هناك من يراقبني بتركيز آخر. ليس من الفضائيين ولا من العامة. إنهم أولئك الذين يفهمون اللعبة. لم أعرف بعد إن كانوا أعداء نهائيين أم مجرد مراهنين. لكنني شعرت أن النهاية لن تكون للنار، ولن تكون للنصر أو الهزيمة فقط. النهاية ستكون لحظة حساب لا يرضى عنها أي منا بسهولة. وأنا، وأنا أعد نفسي لتلك اللحظة، أعرف أن ثمن اقتراب الحقيقة أعلى بكثير مما توقعت. سأدفع ثمناً شخصياً. ربما أفقد ما تبقى من إنسانيتي. ربما أخسر أكثر مما كسبت.
أنهي هذا الجزء وأنا أعلم أن الخطر بات أقرب. الشرطة ليست وحدها في مطاردتي. هناك قوةٌ أخرى تحسب خطواتي. وفي الجزء القادم سأروي كيف اصطدمت مع هذا الخصم، وكيف جعلت خياره يعني لي أكثر مما أردت، وكيف تحولت لعبة الانتقام إلى مفترق طرق فيه تختار حياة أو موت أكثر من مجرد عنوان في صحيفة. استعد لأن الطريق سيصبح أضيق، وأن كل قرار سيترك جرحاً لا ينسى.