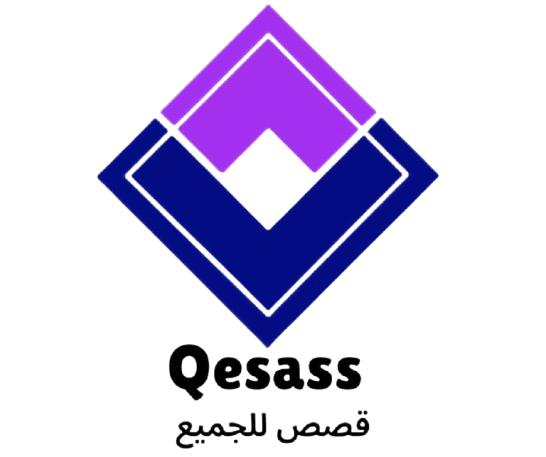في هذه القصة نفتح باباً معتماً على عالمٍ لا يجرؤ كثيرون على النظر إليه. هنا لا نروي قصة بطل ولا نبحث عن ضوء. نحن أمام اعترافات رجلٍ تحوّل إلى أكثر مجرمٍ مرعبٍ في العالم بعد سلسلة من الخيانات والظروف القاسية التي صنعت بداخله وحشاً لا يعرف الخوف. يكشف السارد بصوته هوية الآلام التي دفعته إلى هذا الطريق، ويحكي كيف صار كابوساً يطارد الشرطة ويفوق قدراتهم. قصة ثقيلة، حادة، ومؤلمة، لكنها تكشف جانباً من الحقيقة التي يحاول الجميع دائماً إخفاءها.
القصة
أنا سأرويك الحقيقة كما أراها، بلا تزييف ولا تبرير، لأن الحقيقة عندي سلاح أقوى من كل بنادق العالم. اسمعني جيداً لأن صوتي الآن آخر ما سيسمعه كثيرون قبل أن ينطفئ الضوء عنهم. اسمي لا يهم. كل ما عليك أن تعرفه أنني من صنعوا اسمي في عيون الشرطة، وصاغوا منه أسطورة تخيف الخُبراء وتحرّك أحلام الجواسيس. أُطلق عليّ لقب “الأقوى” لأنني لم أترك لضعفٍ فرصة أن يتسلط عليّ. القوة عندي لم تأتِ من عضلات أو ثروة. القوة حدثت داخل قلبي عندما علمت أن العالم لا يمنح العدالة إلا لمن يعرف كيف يسرقها.
ولدت في زاوية نسيها الناس. لم يُنسَ المكان لأن قلبه عظيم، بل لأنهم لم يبالوا بما يحدث فيه. كان يتوقف أحدنا عند حاجز الكهرباء فقط ليعرف إن فاتورة البيت قد زادت مرة أخرى. كنا نعيش على نفَسٍ واحد، نفَسٍ يتنقّل بين العمل المتقطع، وعدّادات العدوى، وآمالٍ صغيرة تتكسّر كل صباح عند مدخل المدرسة. والدي علمّني لغة البذل ولم يعلمّني لغة الأمان. علمّني أن أقاتل حتى لأحصل على رغيف خبز، كان ذلك أول درس في سرقة القلب من العالم.
تعلمت القراءة من عيون الناس أكثر مما تعلمتها من الكتب. رأيت في وجوههم قصصاً أقصر من قِصاصات الورق، لكن أثقل من تاريخٍ لا نعرفه. الطبيب الذي كنا نظنّه ملاكاً خرج ذات يوم من العيادة وقد سرق نظراتي، ولم يعد يعطيني دواء والدي. المعلم الذي وعدنا بالعالم، صار يعطينا كلمات لا تعني شيئاً. هذه الخيانات الصغيرة تراكمت إلى أن أصبحت قطاراً بلا سائق، يصطدم بكل من يحاول أن يركبه. هذه كانت البداية.
في شبابي التقيت برجل واحد غيّر حياتي بكلمة واحدة. لم يكن زعيم عصابة ولا سيّد أعمال. كان رجل إصلاحات في محكمة الاهتمام. قال لي مرة وحيداً، دون شهود: “القوة الحقيقية ليست في من يملك السيف، بل في من يعرف كيف يجعل الآخرين يخشونه من دون أن يُمسك السيف”. لم تكن تلك نصيحة لي لأسرق أملاك الناس. كانت خطةٌ لي لأقتنص احترامٍ لم يعطني إياه أحد. علمني أن أقرأ خريطة الخوف في عيون البشر. ومنذ ذلك اليوم بدأت أدرس الخوف كمن يدرس لغة أجنبية.
أردت أن أنتقم بعدما رأيت كيف تستغل الحكومات الفاسدة الأطفال، كيف تقدمهم كعملات صغرى في سوق بائس. رأيت رجال الشرطة الذين أقسموا أن يحفظوا النظام يتاجرون بابتساماتهم. رأيت القضاة يضعون أقنعة أخلاق على وجوههم ليأكلوا بها من سلطةٍ ملطخةٍ بالرشاوى. كل هذا علمني أن العدالة ليست نقيمة أخلاقية وإنما لعبة نفوذ. ومن لا يتعلّم قواعدها يبقى خاسراً إلى الأبد.
وها هو أول جرح حقيقي. كانت ليلة سوداء تصطك فيها أبواب المدينة كأنها أسنانٌ جائعة. خرجتُ لأجلب دواءً لشقيقي. لم أجد سوى بابٍ موصدٍ ونداء استغاثة بلا استجابة. في الصباح وصلت الأخبار: حريق في الطابق الأخير. إختفى شقيقي في الدخان، وبدلاً من أن تقف الدولة وتشدّ ذراعي كي أنجو، وجدت وجوه المسئولين تتلون بلون المكسب. لم يحملوا معي كشافاً واحداً. تركوني لأطفئ بيتي بنفس يدي. هناك، أمام الرماد، واجهتُ قرارين: أن أموت ممتلئاً بالأسئلة أو أن أعيش لأردّ السؤال.
اخترت أن أعيش لأن الموت سيكون راحة لمن لا يريد أن يغيّر شيئاً. عشت لأعلّم نفسي كيف أجعلهم يدفعون ثمن لاستخدامهم لقلوبنا كموادٍ أولية. تعلمت كيف أفتح الأبواب المغلقة من دون أن أنطق بكلمة. تعلمت أن أترصد الطقوس البسيطة للسلطة: توقيت اجتماع، اسم الضابط، عادة حارس الباب. ليس لأني أردت أن أهرب بكفاءة، بل لأنني أردت أن أُعلّمهم أن اليأس يولّد صنوفاً من الانتقام لا يعرفونها.
لم تكن جرائمي الوحيدة سرقات بنوك أو خزائن. جرائمي الحقيقية كانت مذكرات أكتبها في وجوههم. كنت أسرق الزمن الذي يقضونه في النوم، وأعيده لشارعٍ لم يعش إلا قليلاً. كنت أترك أمام بواباتهم رسائل صغيرة، ليست هدراً ولا تهديداً. كانت اقتباسات من حياتهم، أجزاءٍ من يومياتهم، لتذكيرهم بأنهم إنسانون قبل أن يكونوا ألقاباً. أكنت أجرم لأنني أقسى أم لأن العالم كان أقسى؟ لا أعلم. ربما كان الجواب في عين طفل فقد أخاه في حريق ولم يجد من يواسيه.
طريقتي في العمل كانت بسيطة فقط في المظهر. أعدّ مثل فلاسفة الحرب. أراقب، أوجد ثغرة صغيرة، وأضع فيها مرآة تعكس وجوههم. لكن لا تظن أنني أعلم بتفصيل كيفية فتح الخزائن. لا. أنا أكتب قصصاً تجعلهم يفتحون خزائنهم بأنفسهم. أزرع في رؤوسهم أحلاماً عن أمنياتٍ لم تتبلور. أما الدافع فكان أبسط من كل هذا: أردت أن أُريهم أن يدا واحدة من الفقراء يمكن أن تكتب تاريخاً أطول من كل سجلاتهم.
الشرطة؟ هم هنا للاستهلاك الإعلامي. رجالٌ يقولون إنهم يلاحقونني، ويطلّون على شاشات الأخبار، لكن في واقعهم هم أشخاص ينهشون بعضهم في مؤسسات تعاني من التهافت. بالطبع جعلتهم يجنون. ليس لأنني أحب الفوضى، بل لأنني أردت أن أعرف إلى أي مدى يمكن لمنصة الكذب أن تصمد قبل أن تنقلب. تركت لهم أدلة خادعة، رسائل مشفرة بلا معنى، خطوط هواتف تقود إلى متاهات تشبه أحلامهم. كل ذلك لأنني أردت أن أراقب كيف يشتعلون عندما لا يجدونني. رؤية الضابط الكبير وهو يسهر وحده في مكتبه، يحاول أن يربط نقاطاً لا وجود لها، كانت متعة لا تُقاس.
لكن لا تفهم هذا كتمجيد. داخلي ثقب واسع، كغرفةٍ لم أعد أعرف بابها. في الليالي الطويلة أسمع صدى ضحكاتٍ قديمة، صدى وجه أخي المفقود، صدى رجل الإصلاحات الذي همس لي عن الخوف. ليس كل انتقام يجعل الإنسان سعيداً. انتقامي شبحي. أصبحت الأقوى لكني أيضاً أصبحت إنساناً بمقاييسٍ جديدة، إنساناً يعرف مثالياً ما يعنيه أن يفقد كل شيء.
الجزء الأول من حكايتي ينتهي هنا لكن ليس لأن القصة توقفت. إنه مجرد التمهيد. ما زال أمامي فصلٌ طويل من الإصلاحات والخيانات والصدامات. ما زال أمامي أن أضع اللغز الأكبر الذي سيجعل الشرطة تتلوى في دوائرها، وسأثبت لهم أن قوة الرجل ليست في قوته الجسدية بل في قدرته على جعل العالم يعترف بخطئه. في الجزء القادم سأحدثك عن السر الذي أبقاني حياً، عن الخطة التي بدأت كوخزة صغيرة فصارت شجرة سودة تغطي سماء المدينة، وعن اللحظة التي قررت فيها أن أجعل النهاية لا تُنسى لكن موجعة. استعد لأن الأمور ستزداد قساوة، لأننا عندما نقترب من قلب الظلام نرى وجهاً لم نره من قبل، وجه يشبهنا أكثر مما نحب أن نعترف.